
403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إعدام برائحة الزمان - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan)
هل بين إعدام سقراط وسيد قطب وجه شبه؟ لماذا انتهى سقراط إلى كأس السُّمّ في أثينا القديمة، وانتهى فكر سيّد قطب إلى خطابِ تكفيرٍ في القرن العشرين؟ هذه المقالةُ تقول إنَّ كلا الاثنين واجها مجتمعيهما عند النقطة التي توقف فيها الزمنُ الاعتقادي. فما معنى ذلك؟
كان الزمنُ في الثقافات والحضارات القديمة قاعدةً يُبنى عليها معتقد المجتمع ومعنى وجوده، بمعنى أنَّ الطريقةَ التي يُزمّن بها الناسُ حياتَهم - آنذاك قبل زمن الحداثة - هي نفسها الطريقة التي يُثبتون بها معتقدَهم، فإذا انهارت البنيةُ الزمنية، انهار معها اليقين. ففلسفة التزمين عند الإغريق تقوم على أنَّ الزمن دائرة كبرى تدور لتُعيد ما مضى في صورةٍ متجدّدة؛ الطبيعة تُعيد فصولها، والطقوس تُعيد أساطيرها، والمدينة تُعيد أعيادها، وهذه العودة ككرةِ الثلج تكبر بالمعنى، وقد تقفز بسبب حصيّات في دربها (كايروس). وربما قد زمَّن الإغريق وجودهم بالدائرة والعودة؛ لأنهم كانوا يُواجهون مخاوفَ ثلاث: الفوضى الطبيعية، والزوال الاجتماعي، والعبث الوجودي، فكانت الغايةُ من التزمين أن يضمنوا للنفس وللجماعة والكون إيقاعًا مطمئنًا، حيث كل شيء يعود، والهوية محفوظة، واللحظة المناسبة ممكنة.
إذن المجتمع الإغريقي كان يتصور الزمنَ دائرةً فجعل من معتقداته طقوسًا وأساطير تُعيد هذه الدائرة وتثبتها، أي إذا كان الزمنُ يُعيد نفسه فإنَّ الأسطورة تُعاد، والطقس يُعاد، والهوية تُعاد، وهذا يعني أنَّ المعتقدَ يستمد ثباته من العودة والدائرة: كل ما يعود يثبت، فمثلًا قيمة العدالة تستمد شرعيتها وقوتها من كونها تعود وتتكرر اجتماعيًا، ومن هنا نفهم أن أيَّ تفكير يُشكك في هذه العلاقة يُعتبر خطرًا على البنية كلها، وهذا ما جرى لسقراط حين رفض أن يكتفي بالتكرار، وسأل: ما الفضيلة؟ وما العدالة؟ أي كأنه قال: ربما العدالة قوية وشرعية؛ لأنَّ لها مصدرًا آخر غير معلوم يحتاج إلى حوار وبرهان، وليس لأنها تتكرر وتعود. هنا بدا سقراط كأنَّه يُريد أن يضع البرهان مكان الإعادة. وبمجرد أن كسر الحلقةَ بدا وجوده خطرًا على البنية كلها؛ ولهذا أعدموه.
أما العربُ قبل الإسلام فالزمن عندهم كان دائريًا وخطّيًا؛ لأنَّهم كانوا موحدين ومعددّين في آنٍ واحد، موحدين لأنَّ ثمة إلهًا واحدًا يخلق ويرزق، ومعددين لأنَّ ثمة آلهة متعددة يرتبط بها الإنسان بالسلوك الاجتماعي للوساطة والهوية والطقس. هذه الثنائية انعكست على زمنهم: خطّية الزمن ميتافيزيقيًا (إله واحد وراء الكون)، ودائرية عملية في طقوسهم ومجالاتهم، وهذه الدائرية هي التي تجعل شرعية القيم وقوتها لديهم تأتي من مجالات حياتهم وطقوسهم الثابتة: الأشهر الحرم، والمواسم والأسواق، وأيام العرب. ولما جاء الإسلام كسر قدسية المجال الدائري عند العرب وحَوَّل القيم إلى مصدر واحد هو الله، ومن ثم فإنَّ الزمن فقط خطي يسير نحو الله، وما مخلوقاته الكبرى في السماء إلا علامات للإنسان في الأرض كي يُحقّق التوحيد الاجتماعي في حياته كلها، لهذا كان زمن الأرض - عند المسلم آنذاك - متعلق بحركة الشمس والقمر، وهذه الحركة زمنية مستقلة تتجلّى متقسّمة في الأرض بمجالات أوقات الصلاة: وقت الفجر من طلوع الفجر إلى الشروق، ووقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والعصر حتى تصفر الشمس، والمغرب حتى غياب الشفق، والعشاء إلى منتصف الليل.
هذا التقطيع الزمني هو الذي يتعامل معه العربي آنذاك في حياته كلها وليس فقط الصلاة، أي كأنَّ أوقات الصلوات هي جدولة ذهنية للعربي كي ينجز أعماله الاجتماعية المرتبطة بدورها بالمعتقد كله؛ لهذا يقول القائل لصديقه: ((اجتماعنا بعد الظهر)) أي كأنه يقول الاجتماع ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، حتى لو لم يكن القائل من أهل الصلاة، ومن ثمَّ فإنه إذا سقطت هذه البنية الزمنية سقط معها المعتقد كله بوصفه فعلًا جماعيًا.
ومع الحداثة دخل العرب في زمن ثالث: زمن الشبكة، الزمن العالمي الموحَّد الذي تديره الساعات الذرية والقطارات والمصانع والهواتف الذكية، زمنٌ متجانس لا يعبأ بالزمن الاعتقادي إنما بقياس الثانية والملّي ثانية، زمن متعلق بالجداول والإنتاج الوظيفي والسرعة. في هذا السياق رأى سيّد قطب أنَّ المجتمعات الإسلامية تخلّت عن تزمينها بالمجال ودخلت في تزمين ساعاتي حديث، واعتبر أنَّ هذا الانخلاع من الزمنِ الاعتقادي هو انخلاع من المعتقد الإسلامي ذاته. فجاء خطابه التكفيري ثم جاء إعدامه.
كان الزمنُ في الثقافات والحضارات القديمة قاعدةً يُبنى عليها معتقد المجتمع ومعنى وجوده، بمعنى أنَّ الطريقةَ التي يُزمّن بها الناسُ حياتَهم - آنذاك قبل زمن الحداثة - هي نفسها الطريقة التي يُثبتون بها معتقدَهم، فإذا انهارت البنيةُ الزمنية، انهار معها اليقين. ففلسفة التزمين عند الإغريق تقوم على أنَّ الزمن دائرة كبرى تدور لتُعيد ما مضى في صورةٍ متجدّدة؛ الطبيعة تُعيد فصولها، والطقوس تُعيد أساطيرها، والمدينة تُعيد أعيادها، وهذه العودة ككرةِ الثلج تكبر بالمعنى، وقد تقفز بسبب حصيّات في دربها (كايروس). وربما قد زمَّن الإغريق وجودهم بالدائرة والعودة؛ لأنهم كانوا يُواجهون مخاوفَ ثلاث: الفوضى الطبيعية، والزوال الاجتماعي، والعبث الوجودي، فكانت الغايةُ من التزمين أن يضمنوا للنفس وللجماعة والكون إيقاعًا مطمئنًا، حيث كل شيء يعود، والهوية محفوظة، واللحظة المناسبة ممكنة.
إذن المجتمع الإغريقي كان يتصور الزمنَ دائرةً فجعل من معتقداته طقوسًا وأساطير تُعيد هذه الدائرة وتثبتها، أي إذا كان الزمنُ يُعيد نفسه فإنَّ الأسطورة تُعاد، والطقس يُعاد، والهوية تُعاد، وهذا يعني أنَّ المعتقدَ يستمد ثباته من العودة والدائرة: كل ما يعود يثبت، فمثلًا قيمة العدالة تستمد شرعيتها وقوتها من كونها تعود وتتكرر اجتماعيًا، ومن هنا نفهم أن أيَّ تفكير يُشكك في هذه العلاقة يُعتبر خطرًا على البنية كلها، وهذا ما جرى لسقراط حين رفض أن يكتفي بالتكرار، وسأل: ما الفضيلة؟ وما العدالة؟ أي كأنه قال: ربما العدالة قوية وشرعية؛ لأنَّ لها مصدرًا آخر غير معلوم يحتاج إلى حوار وبرهان، وليس لأنها تتكرر وتعود. هنا بدا سقراط كأنَّه يُريد أن يضع البرهان مكان الإعادة. وبمجرد أن كسر الحلقةَ بدا وجوده خطرًا على البنية كلها؛ ولهذا أعدموه.
أما العربُ قبل الإسلام فالزمن عندهم كان دائريًا وخطّيًا؛ لأنَّهم كانوا موحدين ومعددّين في آنٍ واحد، موحدين لأنَّ ثمة إلهًا واحدًا يخلق ويرزق، ومعددين لأنَّ ثمة آلهة متعددة يرتبط بها الإنسان بالسلوك الاجتماعي للوساطة والهوية والطقس. هذه الثنائية انعكست على زمنهم: خطّية الزمن ميتافيزيقيًا (إله واحد وراء الكون)، ودائرية عملية في طقوسهم ومجالاتهم، وهذه الدائرية هي التي تجعل شرعية القيم وقوتها لديهم تأتي من مجالات حياتهم وطقوسهم الثابتة: الأشهر الحرم، والمواسم والأسواق، وأيام العرب. ولما جاء الإسلام كسر قدسية المجال الدائري عند العرب وحَوَّل القيم إلى مصدر واحد هو الله، ومن ثم فإنَّ الزمن فقط خطي يسير نحو الله، وما مخلوقاته الكبرى في السماء إلا علامات للإنسان في الأرض كي يُحقّق التوحيد الاجتماعي في حياته كلها، لهذا كان زمن الأرض - عند المسلم آنذاك - متعلق بحركة الشمس والقمر، وهذه الحركة زمنية مستقلة تتجلّى متقسّمة في الأرض بمجالات أوقات الصلاة: وقت الفجر من طلوع الفجر إلى الشروق، ووقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والعصر حتى تصفر الشمس، والمغرب حتى غياب الشفق، والعشاء إلى منتصف الليل.
هذا التقطيع الزمني هو الذي يتعامل معه العربي آنذاك في حياته كلها وليس فقط الصلاة، أي كأنَّ أوقات الصلوات هي جدولة ذهنية للعربي كي ينجز أعماله الاجتماعية المرتبطة بدورها بالمعتقد كله؛ لهذا يقول القائل لصديقه: ((اجتماعنا بعد الظهر)) أي كأنه يقول الاجتماع ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، حتى لو لم يكن القائل من أهل الصلاة، ومن ثمَّ فإنه إذا سقطت هذه البنية الزمنية سقط معها المعتقد كله بوصفه فعلًا جماعيًا.
ومع الحداثة دخل العرب في زمن ثالث: زمن الشبكة، الزمن العالمي الموحَّد الذي تديره الساعات الذرية والقطارات والمصانع والهواتف الذكية، زمنٌ متجانس لا يعبأ بالزمن الاعتقادي إنما بقياس الثانية والملّي ثانية، زمن متعلق بالجداول والإنتاج الوظيفي والسرعة. في هذا السياق رأى سيّد قطب أنَّ المجتمعات الإسلامية تخلّت عن تزمينها بالمجال ودخلت في تزمين ساعاتي حديث، واعتبر أنَّ هذا الانخلاع من الزمنِ الاعتقادي هو انخلاع من المعتقد الإسلامي ذاته. فجاء خطابه التكفيري ثم جاء إعدامه.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

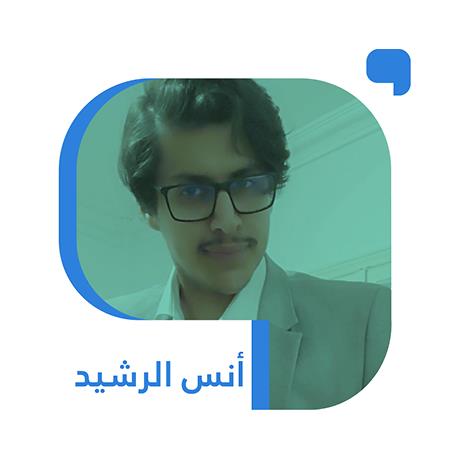












الأخبار الأكثر تداولاً
مساندة تصبح الشريك الأول لبرنامج عزم التابع لصندوق الاستثمارات العامة ...
إسرائيل بين العزلة السياسية والاقتصادية.. خسائر فادحة في صفقات السل...
عمال ستاربكس يرفعون دعاوى قضائية ضد الشركة بسبب تغيير قواعد اللباس...
37 دولة تشارك في ملتقى الشارقة الدولي للراوي...
انقطاع الاتصالات في غزة مع تقدم مشاة ودبابات إسرائيلية...
178 مليار درهم سوق السياحة العلاجية العالمي في 2025...